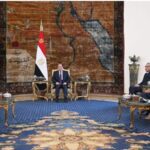نبيل فكري .. يكتب: نحنُ «غرابا عك» !!

الآن .. حالا.. أقرأ هذا النبأ القادم من السودان، حول إعلانه رسمياً تفشي وباء الكوليرا في البلاد .. الثالثة فجراً .. كل شيء مؤرق .. لا شيء يبعث على النوم، رغم أننا في وطن نائم.
من بنايتك الساكنة وسط الضجيج، حيث تصل إلى مسامعك أصوات «السهرانين» قليلي الذوق والأدب، إلى مدينتك المضجرة الغارقة في العبث وفي الألعاب النارية وتباري المارة في الإسفاف، إلى بلدك المتشبث بالحياة رغم ما يكابد، انتهاء بوطنك العربي المبعثر المجنون «اللا منطقي» الدموي، لا شيء يبعث على النوم .. يبدو أن ذلك التفسير الوحيد لهذا السهر المفرط اللا مبرر .. نحن لا نستحق النوم ولا الراحة، ألم يقولوا قديماً: «لا نامت أعين الجبناء»، وهل هناك أجبنُ منّا.
لا أدري لماذا تَرِنُّ تلك الأنشودة العربية القديمة، من أفلام «الأبيض والأسود» في أذني: «نحن غُرابا عَكّ» .. حين راودتني لم تكن لها علاقة بمعناها القديم (قبيلة «عك»، التي أرسلت عبدَيْها الأسودان قبل قدومها، ليُعلما من يطوف حول الكعبة بقدومها للحج) .. فقط ترددت مع معنى أننا العرب كَمَا نحن اليوم «غِربَان» على هذه الأرض، كل ما نصنعه «عكٌّ في عكّ» .. خراب في خراب .. دمار في دمار.
ما هذا الوطن العربي المتفنن في تخريب ذاته ودمار أهله .. ما هذا الوطن الخانع البائس الأحمق .. ما هذا الوطن المتلذذ أهلُه بقتل أهلِه .. كيف اخترعنا هذا المنطق القابل للأسود القاتم ولعكس كل أبجديات الحياة وكيف ارتضيناه درباً للحياة.
أنا لا أفهم تفاصيل المعادلة في السودان، لكني أرى شعباً يقاتل بعضُه بعضاً .. صنف من الجيش، كان صنيعة الجيش، يقوده تاجر «بعير»، يقتتل مع الجيش، والضحية شعبٌ ارتضى علي مَر الزمان «مُر الحياة»، فاستكثروا عليه حتى هذا «المُر»، وفيما يتقاتل الجيش و«الدعم» الذي لم يعد دعماً، يرزح السودانيون تحت واقع مريع، لتأتيهم الكوليرا، تلون هي الأخرى واقعهم الأسود، بلون أسود جديد.
ومن «الدعم» والجيش في السودان، إلى «الحوثي» والدولة في اليمن، إلى ليبيا التي تبحث عن درب وكأنها تبحث عن حل معادلة لا حل لها، إلى سوريا التي أصبحت أطلالاً، والعراق الباحث عن طوق نجاة، وفلسطين التي تُباد تحت سمعنا وبصرنا، تبدو المشاهد عنواناً لوطن ضل الطريق.
لا أدري كيف أتخلص من تلك الأناشيد القديمة: وطني حبيبي، وأمجاد يا عرب أمجاد، ولا أدري كيف صدقت تلك الأناشيد، رغم أن الوطن لم يكن حبيبي يوماً، فتأشيرات الدخول إليه أصعب من الميلاد، ولم أرى فيه أمجاداً منذ عشرات السنين وبالتالي لم أرى تلك الأمجاد تكبر، كما «يطنطن» الأستاذ عبدالوهاب، ولا أدري من ألّفوا تلك الكتب التي درسناها، كيف صنعوا هذا المزيج العجيب من الكذب والخداع، لكن ما أدريه أنني كنت أصدِّق، يوم كنت في قريتي البعيدة، لا شيء يأتيني سوى صوت الراديو يضج بالأغاني الكاذبة، وورقة تسللت خلسة إلى قريتنا في «قرطاس طعمية» تحمل إلينا «الزيف» بلون «الزيت».
لا أدري هل هي معضلة كبرى أن نحيا .. أن نتصالح .. ألا نكذب .. هل هي معضلة كبرى أن يجلس الدعم «العنيف» مع جيش بلاده ويتفقوا على صالح بلدهم، أو أن يتخلى «الحوثي» عن صلفه من أجل «يَمَنِهِ» الذي كان سعيداً، وأن ينحاز قادة ليبيا لليبيين، وأن تعود سوريا .. لا أدري ما المعضلة في أن نُقر أن «واحد زائد واحد يساوي اثنين» وأن الأبجدية تبدأ بألفٍ باء .. لا أدري لماذا صعّبوها هكذا وأبكونا هكذا وقتلونا هكذا.
أُقر أنه ليست هكذا «تُورَدُ الإبل» ولا هكذا تكون الكتابة، وأن تلك السطور التي مضت ليست إلا موضوع تعبير «بدائي» عن حلم تلميذ بوطنه «الأكبر» «اللي كل يوم أمجاده بتكبر»، لكن ماذا أفعل حيال ما لا أفهم .. كيف وقد اكتشف التلميذ الخديعة الحين، بعد أن أصبح في الخمسين .. كيف وقد اعتراه الشك، وأيقن متأخراً أننا لسنا سوى «غرابا عك».